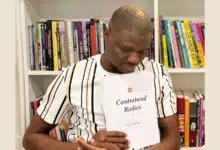سافانا الثقافي – فيرونيك تادجو (مواليد 1955) كاتبة وشاعرة وروائية وفنانة من ساحل العاج، بعد أن عاشت وعملت في العديد من البلدان داخل القارة الأفريقية والشتات تشعر أنها لعموم إفريقيا، بطريقة تنعكس في الموضوع والصور والتلميحات من عملها.
حوار مع الشاعرة والروائية فيرونيك تادجو من ساحل العاج
وُلدت فيرونيك تادجو في باريس وهي ابنة موظف حكومي من كوت ديفوار ورسام ونحات فرنسي، نشأت في أبيدجان كوت ديفوار، سافرت على نطاق واسع مع عائلتها، وأكملت تاجو درجة البكالوريوس في جامعة أبيدجان ودكتوراه في الأدب والحضارة الأفريقية الأمريكية من جامعة السوربون، وفي عام 1983 التحقت بجامعة هوارد بواشنطن العاصمة في منحة فولبرايت البحثية.
مهنة: في عام 1979، اختار تادجو تدريس اللغة الإنجليزية في مدرسة Lycée Moderne de Korhogo (مدرسة ثانوية) في شمال كوت ديفوار، وأصبحت بعد ذلك محاضرة في قسم اللغة الإنجليزية بجامعة أبيدجان حتى عام 1993، وفي عام 1984 نشرت كتابها الأول في الشعر ، Latérite / Red Earth، وحازت على جائزة أدبية من وكالة التعاون الثقافي والتقنيات، وتم تضمين كتابات تادجو في مختارات عام 1992 بعنوان “بنات إفريقيا”، من تحرير مارجريت بوسبي.
في عام 1998 شاركت في مشروع “Rwanda: Ecrire par devoir de mémoire” (رواندا: الكتابة من أجل الذاكرة) مع مجموعة من الكتاب الأفارقة الذين سافروا إلى رواندا للإدلاء بشهادتهم على الإبادة الجماعية في رواندا وعواقبها، وظهر كتابها L’Ombre d’Imana (2000) من وقتها في رواندا.
في السنوات القليلة الماضية قامت بتسهيل ورش عمل في كتابة وتوضيح كتب الأطفال في مالي وبنين وتشاد وهايتي وموريشيوس وغيانا الفرنسية وبوروندي ورواندا والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا، وفي عام 2006 شاركت في الإقامة الخريفية لبرنامج الكتابة الدولي بجامعة أيوا، وعاش تادجو في باريس ولاغوس ومكسيكو سيتي ونيروبي ولندن . استقرت في جوهانسبرغ بعد عام 2007 كرئيسة للدراسات الفرنسية في جامعة ويتواترسراند .
الجوائز التي حصل عليها فيرونيك تادجو
حصلت تادجو على الجائزة الأدبية من وكالة التعاون الثقافي والتقنية في عام 1983 وجائزة اليونيسف في عام 1993 لمامي واتا والوحش ، والذي تم اختياره أيضًا كواحد من أفضل 100 كتاب في إفريقيا في القرن العشرين ، وهو واحد من أربعة كتب أطفال فقط. الكتب المختارة.
في عام 2005 ، فازت تادجو بالجائزة الكبرى الأدبية لأفريقيا نوار وفي عام 2016 جائزة برنار دادي الوطنية الكبرى للأدب . فاز كتابها الصادر عام 2021 بعنوان In the Company of Men بجائزة Los Angeles Times Book for Fiction. [13] [14

مقابلة مع فيرونيك تادجو
صدرت النسخة الفرنسية الأصلية في عام 2017. في ذلك الوقت، لم يكن أحد يتوقع جائحة فيروس كورونا، ثم تُرجم الكتاب إلى اللغة الإنجليزية ونشرته دار أخرى برس (الولايات المتحدة) وهوب رود (المملكة المتحدة) في عام 2021 أثناء الأزمة الصحية، والجواب البسيط هو أنني لم أر قط شيئًا مثل الإيبولا وهو مرض يمكن أن يتسبب في الكثير من الدمار في مثل هذا الوقت القصير، ولقد نشأت في أبيدجان.
تشترك كوت ديفوار في الحدود مع غينيا في الشمال، وليبيريا في الغرب لذلك أصبحت قلقة للغاية، وكان المرض يتقدم بسرعة، وعندما زرت أبيدجان من جوهانسبرغ حيث كنت أقوم بالتدريس في جامعة ويتواترسراند، في ذلك الوقت كانت هناك قيود صحية صارمة ولم نتمكن من التقبيل ولم نتمكن من العناق، واضطررنا إلى غسل أيدينا بالكلور، ولقد صدمت لذلك عندما عدت إلى جنوب إفريقيا، واصلت متابعة تطور الوباء عن كثب، وربما هذا شيء مشترك مع الناس “في المنفى”، وإنهم قلقون كثيرًا بشأن ما يحدث في المنزل وكان الإيبولا في الأخبار كثيرًا في مرحلة ما.
عندما انتهى الوباء في عام 2016 لم يعد أحد يريد التحدث عنه بعد التدقيق الإعلامي المكثف وأصبح نوعا من المحرمات، ولقد حيرتني كثيرًا وفكرت لا نحن بحاجة إلى التوقف والتفكير في هذا الشيء الضخم الذي حدث للتو، ونحن بحاجة إلى المحاولة والعمل بها على المستوى البشري، وذلك عندما قررت أن أكتب الكتاب، وكلما بحثت في الموضوع زادت عزيمتي على الاستمرار في مشروعي، وعلمت أنه كان هناك ما لا يقل عن عشرة أوبئة سابقة للإيبولا حدثت في جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث تم التعرف على الفيروس لأول مرة في عام 1976.
وأن هناك أنواعًا مختلفة من فيروسات الإيبولا معروفة بوجودها في السودان وأوغندا وكوت د. Ivoire، وحتى في آسيا بدرجات متفاوتة من الفتك، وحتى نيجيريا والسنغال ومالي كانت لديها مخاوف خطيرة لكنها تمكنت من احتواء المرض بنجاح قبل أن يخرج عن السيطرة، ولكن في الوقت الذي نتحدث فيه هناك تفشي مستمر تم الإعلان عنه في 20 سبتمبر 2022 والذي سببه فيروس الإيبولا السوداني في المنطقة الغربية والمنطقة الوسطى من أوغندا، وهذا هو الفاشية الخامسة في أوغندا.
ما الذي ألهم عنوان الكتاب: في صحبة الرجال؟
العنوان يشير إلى تغيير النظرة، والحيوانات والطبيعة في صحبة الرجال، والبشر ليسوا فوق المخلوقات الأخرى، والعالم ليس لنا وحدنا ونحن لا نمتلكها، ونحن ندمرها على مسؤوليتنا الخاصة، وكما تقول شجرة التبلدي العملاقة في الكتاب “لكن عندما يقتلنا الرجال، يجب أن يعلموا أنهم يكسرون قيود الوجود، ولم يعد بإمكان الحيوانات العثور على طعام.
ولم يعد بإمكان الخفافيش العثور على الطعام ولم يعد بإمكانهم العثور على الفاكهة البرية التي يحبونها كثيرًا، وثم يهاجرون إلى القرى، حيث توجد أشجار المانجو والجوافة والبابايا والأفوكادو، مع ثمارها الطرية الحلوة، وتسعى الخفافيش إلى رفقة الرجال.
كم استغرقت من الوقت لإجراء البحث المطلوب لإكمال هذا الكتاب؟
أود أن أقول منذ عام 2014 عندما أصبح وباء الإيبولا مصدر قلق رئيسي، حتى كتابة الكتاب وكوني أكاديميًا ساعدني بشكل كبير (من حيث المنهجية التي يجب اتباعها) عند إجراء البحث لأنه يمكن تطبيق نفس المهارات على الكتابة الإبداعية، وعند إنتاج مقال أكاديمي، يُقال إن عليك الانسحاب وراء “الحياد” والبقاء على المسار “العقلاني”، ومن ناحية أخرى عندما تكتب بشكل إبداعي، فإنك تميل إلى التركيز على المعرفة العاطفية، وأنت تناشد إحساس القراء بالتماهي مع الشخصيات لأنك تريد كسر دائرة اللامبالاة، إلى حد ما ويفتح هذا النموذج الهجين إمكانيات جديدة.
ولقد قلت ذات مرة “لتتمكن من الكتابة بشكل جيد، يجب أن تكون صادقًا تمامًا، ولكن في كثير من الأحيان الحقائق التاريخية هي التي تسيطر، ويجب أن يطبق النص حقيقته الخاصة وإنه ليس ريبورتاج، وهذا ليس نص جامعي إنه الأدب، ولكن هل هناك لحظة فكرت فيها في كتابة هذه الرواية، واستحوذت الحقائق بالكامل؟
نعم، لم يكن غربلة جميع البيانات أمرًا سهلاً، وعندما جلست أخيرًا لكتابة الكتاب تكثف بحثي لأنه كان عليّ سد الثغرات، ولكن بطريقة ما كنت أعرف بالفعل ما كنت أبحث عنه، ولا يزال يتعين علي القيام بالكثير من التقليم والتلويث، ولم تكن نيتي أن أكتب عملاً شاملاً، وعلى سبيل المثال كان بإمكاني إضافة المزيد من “الشخصيات” لكنني استقرت على تلك التي تحدثت معي بشكل عاجل لهذا الغرض، ونسجت الحكايات والواقع لأجمع معًا، “سلسلة قصصية شبه سحرية لكنها نزيهة بشدة”، كما قال أحد النقاد، كان من المهم بالنسبة لي أن أرسم هذه الصورة لمرض أودى بحياة أكثر من 11 ألف شخص.
هناك إيقاع شاعري لأسلوب كتابتك؟
وهل تعمدت إدخال الشعر في روايتك أم أنه حدث بشكل طبيعي أثناء عملية الكتابة: أرى الشعر على أنه طريقة للنظر إلى العالم، ويجب أن يكون مجانيًا وفي الخارج، أعاد شعر الكلمات المنطوقة الشعر إلى مكانه في المجال العام وليس محصوراً في صفحات مجموعات القصائد. لقد استعاد الشعر شفاهه وقدرته على القتال، ويمكن أن يكون غنائيًا ولكنه أقل من نوع حميمي وأحيانًا محكم.
إنجذب إلى النثر الشعري لأنه يسمح لي بكتابة أعمال تستخدم لغة مكثفة وصورًا قوية، والشعر هو وسيلة أخرى للتعبير مثل الرسم أو الموسيقى، ويحثك على العثور على الطريق الأكثر مباشرة إلى الوداجي، واستخدمت في هذه الرواية إيقاعًا شعريًا للتعبير عن الحزن والأسى لمن مات، وترنيمة لمن نجا.

لماذا تعتقد أنه من الضروري التعرّف على تأثيرات فيروس الإيبولا من وجهات نظر مختلفة لشخصيات غير مسماة؟
لم تكن الحرب ضد فيروس الإيبولا قصة خطية، ولقد شارك عددًا كبيرًا من الأشخاص وكان لها أبعاد معقدة ومتعددة الطبقات، وبدا لي أن الاستماع إلى أصوات مختلفة كان وسيلة فعالة للاقتراب من شكل من أشكال “الحقيقة”، ولم أستطع التركيز على صوت واحد فقط، ومن خلال تقديم وجهات النظر العديدة، بما في ذلك وجهات النظر غير البشرية قاومت إغراء تقييم الواقع من حيث المعرفة والقيم الإنسانية وحدها، وكان من المهم تقديم شكل من أشكال التضامن كمساءلة.
وكان لدي هيكل سرد القصص للتقاليد الشفهية الأفريقية وأخرى يونانية في الاعتبار، كنت مهتمًا بإبراز نظرة أكثر شمولية للعالم، مستمدة من الاعتراف بضعف وجودنا، ويعتمد البشر على غير البشر والعكس صحيح، والخيال وسيلة للابتعاد عن الوضع الراهن لإعادة تقييم المأزق الذي نجد أنفسنا فيه.،لودي شك غريزي في القصة الخطية، ونحن بحاجة للاستماع أكثر لبعضنا البعض.
ودعونا نتحدث عن تلك الشخصيات غير البشرية، مثل شجرة الباوباب والخفافيش وحتى الفيروس نفسه كلهم رواة في هذه الرواية، وشجرة التبلدي شخصية مركزية وأنت تصورها على أنها إلهية وخالدة تقريبًا ورمزًا للشفاء، وتشير مرثاة شجرة الباوباب إلى تفاهة الأنثروبوسين وهو كتاب تؤكد فيه الكاتبة هيذر آن سوانسون، أن أكثر ما يثير القلق بشأن تدمير البيئة “هو العدد الهائل من الأشخاص الذين أخفقوا في إزعاجهم”، ثم تدعو إلى الفضول باعتباره ترياقًا لـ “العمى”.
والخفافيش والفيروس موجودان أيضًا لإبداء الرأي حول الوضع، وإنهم يستخلصون استنتاجاتهم من ملاحظتهم لكيفية تصرف البشر، وشجرة التبلدي هي الجريوت والراوي، والشخصية المركزية لأنه يدعم الثقة في قدرة البشرية على إصلاح نفسها، يبقي الأمل طافيا.
هل تعتقد أن معركة البقاء على قيد الحياة تغلب على الحزن الذي يشعر به المرء بعد فقدان أحبائه؟
نعم بالنسبة لي الحياة أقوى من الموت، والمرونة والبقاء يدوران حول استمرار دورة الحياة، ونحن مدينون للأموات الذين لولا ذلك كانوا سيقعون في النسيان، وإنهم يحتاجوننا مثلما نحتاجهم، وهناك قصيدة جميلة لبيراجو ديوب، كاتب سنغالي رائد بعنوان “الأرواح” (سوفليس بالفرنسية ، 1960)، وإنه يعبر بشكل جميل عن الإيمان بوجود صلة بين الأحياء والأموات.
ويبدو الأمر كما لو أن الناس في سن معينة يقبلون الموت كجزء من النتيجة النهائية للحياة، ومع ذلك بالنسبة للجيل الأصغر، لا يعني ذلك أنهم غير مدركين للموت، فهم لا يريدون ذلك على أعتاب منازلهم كضيف مألوف، ولماذا تعتقد أن هذا هو الحال؟
أعتقد أنه من طبيعة الشباب أن يعتقدوا أن الموت لا يعنيهم، ويريدون المضي قدما، ولا يرغبون في أن يبطئهم أي شيء، ولكن الأحداث الأخيرة كان ينبغي أن تغير ذلك، ومع هذا الوباء أصبح من الصعب للغاية النظر إلى الموت على أنه حكر على كبار السن فقط، والأجيال الجديدة تواجه تحديات ضخمة، ولقد ورثوا عالما مضطربا، وسوف يحتاجون إلى رؤية واضحة وكثير من الشجاعة، والموت هو اليقين الوحيد الذي لدينا وهو ديمقراطي للغاية، وكل كائن حي على الأرض سيموت في مرحلة ما.
والحشرات لها عمر قصير والأفيال تعيش أطول منا، في حين أن بعض الأشجار عمرها قرون، لكننا سنصل جميعًا إلى نهاياتنا، لذلك، ليس الموت هو المشكلة ولكن كيف نموت، إنها ظاهرة طبيعية يجب أن نستعد لها جميعًا وتعلمنا الحيوانات الكثير، وهم أيضا يشيخون ويموتون ولكن ليس لديهم هذا الدافع للتملك والهدر، إنهم لا يأكلون حتى أكثر مما يحتاجون، وإن البشر هم الذين يسمنونهم عمدا ونحن البشر لسنا الكائنات المتفوقة التي نعتقد أننا، كيف نموت وكيف نلحق الموت بالآخرين هي مسؤوليتنا.

في الرواية، ذكر منظور الممرضة كيف كانت النساء أكثر تضررًا من فيروس الإيبولا لأنهن من يقدمن الرعاية وعادة ما يكون آخر من يطلب العلاج، ما مدى صحة هذا؟
لقد أسست هذا على الحقيقة، ولاحظ هذه الظاهرة بشكل يومي وفي المجتمعات المحلية، تكون النساء عادة مقدمات الرعاية، ويرعين الصغار والكبار، وضعوا الأسرة أولا خلال وباء الإيبولا، وكانوا في طليعة المعركة، وفي المستشفيات تجاوز عدد الممرضات المعرضات مباشرة للمرض عدد الأطباء، في بداية الوباء لم يتم تزويدهم بالمعدات المناسبة، ولسوء الحظ يجب أيضًا أن تأخذ في الاعتبار حقيقة أنه في المجتمع الاستبدادي، لا تعتبر النساء صانعي القرار الرئيسيين.
تكتب عن تجاهل الإنسان للبيئة وكيف أدى ذلك إلى تفشي الفيروس؟
هل تعتقد حقًا أنه كان من الممكن منع تفشي فيروس الإيبولا ؟ ليس بالضرورة حتى العلماء لا يفهمون تمامًا سبب تفشي المرض وما الذي يسببها، وهناك الكثير من الفيروسات في الحقيقة نحن نتعايش معهم على أساس يومي، وبعضها غير ضار بينما البعض الآخر يمكن أن يكون مميتًا للغاية، ولكن يبدو أن الجميع يتفقون على شيء واحد وهو عندما ينهار النظام البيئي، لا توجد ضوابط وتوازنات بعد الآن.
ولا تستطيع الطبيعة القيام بعملها في الحفاظ على سلامة الأنواع في البيئة، ونحن بحاجة إلى ميثاق عدم اعتداء بين البشر والطبيعة، وأعلم أنه يبدو حلوًا جدًا وطوباويًا لكنه ليس كذلك، وهناك علاقة لا يمكن إنكارها بين وباء الإيبولا في غينيا وسيراليون وليبيريا وإزالة الغابات الكبيرة التي تحدث في تلك البلدان، وهذه ليست ظاهرة حديثة.
وعليك أيضًا أن تأخذ في الاعتبار حقيقة أن البلدان الثلاثة المعنية كانت في ذلك الوقت، غير مستعدة تمامًا لمواجهة تحديات مثل هذا التفشي، وكانت الأنظمة الصحية غير الملائمة، والمستشفيات القديمة وسوء المعدات، ونقص العاملين الطبيين المدربين، بمثابة عاصفة كاملة، وإن عدم المساواة المرتبط بالاحترار العالمي يلقي بثقله على القارة، في حين أن البلدان الأفريقية هي من بين البلدان التي تنبعث منها أقل نسبة من ثاني أكسيد الكربون، إلا أنها مع ذلك من بين البلدان التي تعاني بالفعل أكثر من غيرها من ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض.
وسوف يزداد وضعهم سوءًا إذا لم يتم تكثيف الجهود لصالح البيئة، وفي البلدان الغنية ستكون أحدث الابتكارات قادرة على الحد من التأثير الضار للتلوث (السيارات الكهربائية ، والطاقات المتجددة ، وتنقية الهواء ، والزراعة العضوية ، وإعادة تدوير القمامة ، وما إلى ذلك) ، بينما في الاقتصادات الناشئة، ستكون التكنولوجيا البيئية شبه معدومة لا تكون قادرة على وقف الكارثة.
ومع ذلك لأسباب مالية، من المستحيل مطالبة البلدان الأفريقية بعدم استغلال مواردها الطبيعية غير المتجددة، وفي الحقيقة تريد الحكومات الوصول إلى الإيرادات التي تولدها ولا توافق حتى لو كانت لا تزال قادرة على أن تصبح بلدانهم مستودعات بيئية أو رئات أكسجين للكوكب، ويجب أن يحدث شيء ما لأن وعود المساعدة من الدول الغربية قد لا تأتي في الوقت المناسب، لا سيما بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
في رواية الرجال
تستكشف بعض الموضوعات الثقيلة مثل الانفصال والتغريب والوصم والموت. هل كانت عملية الكتابة تكلفك عاطفيًا بكتابة هذه الرواية؟ نعم وجدت صعوبة في بعض الأحيان، لكن التضامن الهائل الذي تم وضعه والشجاعة غير العادية التي أظهرها الأشخاص “العاديون” جعلت من الكتابة قصة مشجعة وليست حزينة، ويشيد الكتاب إلى حد كبير بالطاقم الطبي المحلي والمواطنين العاديين والمتطوعين الدوليين الذين تقدموا وتعاونوا في القضاء على المرض
الرواية ليست كلها كئيبة وكئيبة.
إنه يلقي الضوء على أولئك الذين حاربوا الموت ونجوا ليعيشوا يومًا آخر، هل هذا درس متقن في المرونة لقرائك ودرس مهم في الشجاعة، علينا أن ننظر في الاحتمالات التي يمكن أن توفرها الأزمة، ويعود إلى مسألة الذاكرة وما يمكن أن نتعلمه من الماضي، ولا يمكننا وضع غطاء على الأحداث لا سيما عندما يكون هناك الكثير من وصمة العار والصدمات، ويجب أن نكون أقوى، وانظر إلى ما يحدث مع جائحة Covid-19 في الغرب.
ولقد تم إطلاق العديد من المبادرات للتأكد من أن الناس لن ينسوا أنهم سيستخلصون دروسًا مهمة من هذه الأوقات غير المسبوقة، والأمر كله يتعلق بالتعلم وإيجاد المزيد من التوازن والإنصاف في حياتنا، ويريد الكثير من الناس هذا ويعملون من أجله، لذلك أنا متفائل بحذر بأن الأمور تتغير وأنه ستكون هناك موجة أقوى من الوعي البيئي، وهناك الكثير من الضغط على الحكومات الأفريقية لكي تعمل بشكل أفضل فيما يتعلق بالبيئة.
إقرا المزيد: